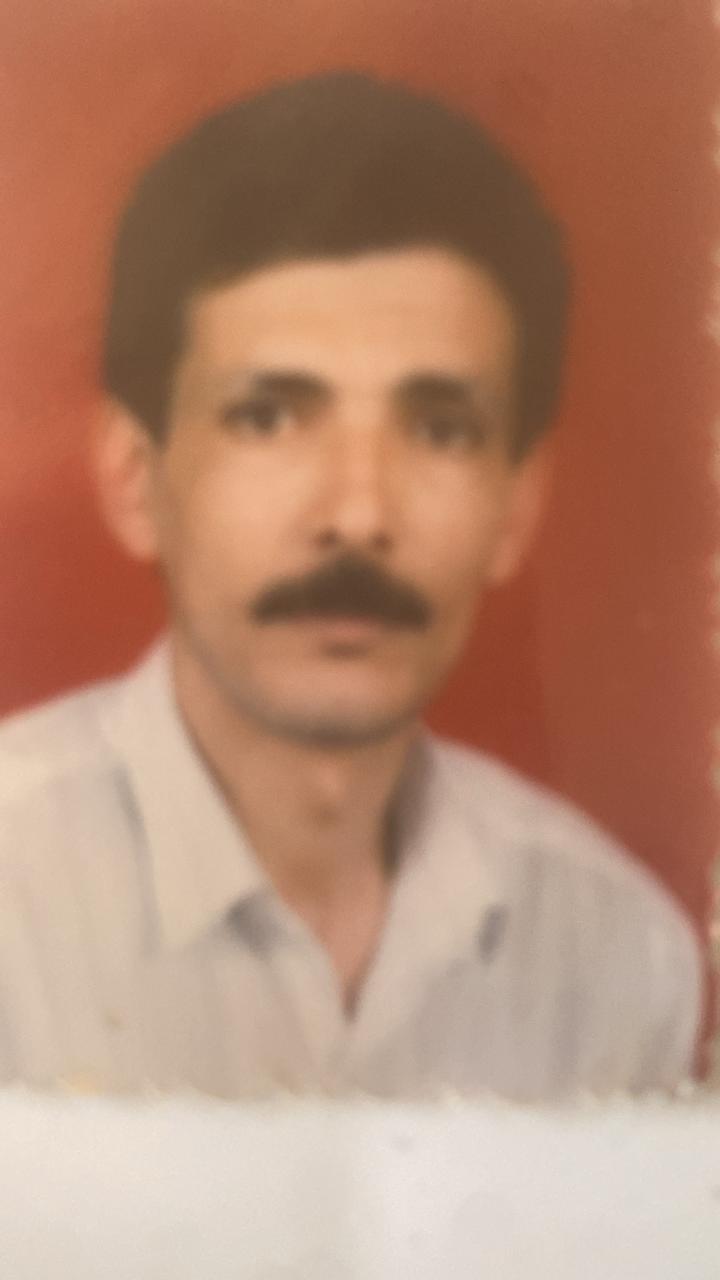نبض البلد - خليل زعتره
شكلت الأوبئة، وخاصة وباء الطاعون الدملي تحدياً حضارياً للمجتمعات في العالم القديم المتأخر قبل الإسلام، فقد كان يتسبب في زيادة نسبة الوفيات وهروب السكان وبالتالي ينخفض الانتاج في المجال الاقتصادي مما يؤدي إلى تدهور الحالة المعيشة وتخلخل النظام الاجتماعي والانحلال الحضري. وكانت مناطق واسعة في العالم –قبل الإسلام- عرضة لجائحات وباء الطاعون الدملي التي غالباً ما تكررت دورياً منذ النصف الثاني من القرن السادس الميلادي منها بلاد الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية، ما عدا وسطها، وبلاد الرافدين وآسيا الصغرى، وهذه المناطق معظمها كان يخضع لحكم الأكاسرة وأباطرة الروم.
في شبه الجزيرة العربية تفاوت تأثير وباء الطاعون بسبب تفاوت انتشاره في أقاليم جزيرة العرب، فقد انتشر على سواحل اليمن وعمان جنوباً، وعلى سواحل خليج عمان الخليج العربي شرقاً، وسواحل تهامة غرباً، ومن السواحل كان يتحرك الوباء وينتقل إلى المناطق الداخلية، وتوجد إشارات أن الطاعون وصل إقليم الحجاز قبل الإسلام، فسواحله محسوبه على إقليم غور تهامة. لهذا اكتسب وباء الطاعون أهمية خاصة عند القبائل العربية في شبه جزيرة العرب والقبائل العربية العراقية والقبائل العربية الشامية، وحسب المصادر الإسلامية والأجنبية والأثرية حملت السفن التجارية القادمة من الهند والصين والحبشة الوباء إلى موانىء اليمن وعُمان، ووصل الوباء إلى غور تهامة الواقع على ساحل البحر الأحمر، وتقع على سواحله ميناء "الشعيبة" الميناء الرئيسي لمكة وما حولها وميناء "الجار" الميناء الرئيسي ليثرب (المدينة) وما حولها قبل الإسلام وفي الإسلام الأول، أما البضائع المنقولة من الهند والصين إلى بلاد فارس، فإن الأبلة (البصرة) التي كانت تدعى فرضة الهند، منها كانت تشحن البضائع بالسفن الصغيرة إلى بلاد فارس وموانىء الخليج العربي، وعن طريقها انتقل الوباء إلى شرق شبه الجزيرة العربية. أما إقليم نجد الواقع وسط شبه الجزيرة العربية والمحاط بوباء الطاعون من الجهات يبدو أنه نجا من الطاعون قبل الإسلام وبعده، فالإقليم معزول تقريباً، إذ تحيط به الكثبان الرملية من ثلاثة جهات ويفصل بينه وبين إقليم الحجاز سلسلة جبلية.
في حياة النبي –صلى الله عليه وسلم- وقعت جائحة وباء طاعون في بلاد الشام بين 598- 601 م، أي قبل بدء البعثة النبوية بعشر سنين تقريباً، وحسب المصادر الإسلامية مات في هذه الجائحة حواالي ثمانين رجلاً من قريش كانوا في طريق عودتهم بقافلتهم التجارية من بصرى الشام إلى مكة، أفناهم الطاعون جميعاً إلا رجلين نجوا، فأكملا المسير إلى مكة. وقد ذكر حسان بن ثابت شاعر الرسول -صلى الله عليه وسلم- قبل إسلامه أبيت شعر يشير فيها إلى وباء عنيف أصاب بشرى الشام وقرى فلاحية تعود إلى قبيلة غسان العربية، وإحدى هذه القرى عبارة عن قصور يعيش فيها أمراء غسان، وجميع من يسكن هذه الأماكن أبادهم الطاعون بلا رحمة، وقد وصف الشاعر حسان "وخز جن" وهو اسم الطاعون قبل الإسلام بأنه "دخان حريق كالأعاصير".
بعد البعثة النبوية بثمان سنوات ضرب جائحة وباء طاعون الاسكندرية بين 618- 619 م وانتقل الطاعون منها بالسفن إلى القسطنطينية عاصمة الروم وانتشر داخل مصر التي قام الفرس باحتلالها وسبق ذلك احتلالهم لبلاد الشام. هذا الوباء انتقل من مصر إلى الحبشة (التي كانت تضم جزءاً من السودان اليوم) وإلى بلاد الشام ووصلها في 4 هـ/ 626 م واستمر فيها حتى 6 هـ/ 627 م، ومن الشام انتقل إلى الجزيرة الفراتية والعراق في 5 هـ/ 626 م واستمر حتى 6 هـ/ 628 م، ثم تحرك الوباء من العراق إلى بلاد فارس. أطلق الفرس على هذه الجائحة اسم (طاعون شيرويه). هذا الانتشار الجغرافي الواسع لهذه الجائحة يعني توفر إمكانية وصول وباء الطاعون إلى سواحل إقليم غور تهامة غرب شبه الجزيرة العربية المتصل بإقليم الحجاز، وإلا ما هو مبرر أن يسأل الصحابة وعائشة زوجة النبي –صلى الله عليه وسلم- في هذه الفترة، ما هو الطاعون؟
الخليفة أبو بكر الصديق عندما بدأ يرسل جيوش الفتح للشام والعراق كان يبايعهم على الطعن والطاعون ويدعو الله عز وجل، بالقول: "اللهم ارزقهم الشهادة طعناً وطاعوناً"، ولا يوجد ما يشير في المصادر الإسلامية والأجنبية إلى وقوع جائحة وباء طاعون في عهدة، ولكن هذا لا يمنع من وقوع حالات من الإصابات الفردية أو فئوية هامشية أومحلية أو مناطقية محدودة التأثير، وسبب وقوع هذه الحالات أن مرض الطاعون مستوطن في بلاد الشام والعراق، وفي عهد عمر بن الخطاب انفجرت جائحة وباء طاعون بالشام في شتاء 16 هـ/ 637 م وتحرك الوباء وانتقل وارتحل إلى مصر والجزيرة الفراتية والعراق وبلاد فارس بين 17- 21 هـ/ 638- 642 م، وقد حملت هذه الجائحة في الشام اسم "عام طاعون عمواس"، وكانت في غاية الخطورة على مشروع الفتح الإسلامي للشام والعراق، ولعبت هذه الجائحة الوبائية الدور الرئيس في توجيه كل الأحداث اللاحقة على كل المستويات.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يحفز على إعادة تقييم جائحة وباء الطاعون في عهد عمر بن الخطاب؟ من أهم أسباب إعادة تقييم هذه الجائحة:
أولاً: أن هذه الجائحة لا تنحصر في فاشيات الوباء التي ضربت في 18 هـ/ 639 م ومات فيها أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهما الكثير من المسلمين.
ثانياً: أن هذه الجائحة انفجرت في شتاء 16- 17 هـ/ 637- 638 م ولم تنحصر في بلاد الشام فقط، بل ضربت مصر والجزيرة الفراتية والعراق وبلاد فارس، وقد حمل الوباء في كل إقليم اسماً مغايراً، وتجدر الإشارة في هذا السياق أن هذه الجائحة تفاوت تأثيرها وشكل انتشار فاشياتها في كل إقليم عن الآخر، ومثل هذه العناصر تستدعي إعادة التقييم.
ثالثاً: في إقليم الشام ضربت جائحة الطاعون بين 16- 18 هـ/ 637- 639 م، وحملت في المصادر الإسلامية أسماء متعددة متقاربة المعنى، مثل: "طاعون عمواس"، و"عام عمواس"، و"عمواس عام الطاعون بالشام"، و"عام طاعون عمواس"، وأطلق المسلمون أسماء مخصوصة على بعض فاشيات هذه الجائحة، منها: "الطاعون في الشام"، أي في دمشق سنة 1أي في دمشق سنة 17 هـ/ 638 م، و"يوم جسر عموسة" و"طاعون الجابية" سنة 18 هـ/ 639 م.
رابعاً: ضربت هذه الجائحة العراق بين 16- 18 هـ/ 637- 639 م، وأطلق أهل العراق على وباء الطاعون اسم "طاعون شيرويه بن كسرى"، وبعضهم أسماه "طاعون شيرويه الملك"، وهذا الاسم لا علاقة له بجائحة وباء "طاعون شيرويه" الذي وقع في العراق في حياة النبي –صلى الله عليه وسلم- بين 6- 7 هـ/ 626- 628 م، وحملت هذه الجائحة اسم "طاعون يزدجرد" الذي وقع بين 18- 21 هـ/ 639- 642 م في بلاد فارس، ولم تحمل هذه الجائحة التي وقعت في مصر بين 16- 21 هـ/ 637- 642 م اسماً، رغم وجود الكثير من الإشارات التي تؤكد وقوع وباء الطاعون فيها.
خامساً: إن أخبار هذه الجائحة في عهد عمر بن الخطاب لم تخضع للفحص والنقد كظاهرة اجتماعية تاريخية عالمية ظهرت وتطورت قبل الإسلام وبعد الإسلام الأول، الأمر الذي يتطلب مراجعة أشمل وأعمق لأحداثها في الزمان والمكان وتأثيراتها ونتائجها من أجل استعادتها إلى مكانها الطبيعي في مجال التاريخ.