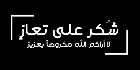نبض البلد -
أحمد الضرابعة
لطالما حفّز الواقع العربي المعاصر ومآسيه الكثيرة، الباحثين والكتّاب على النبش في التاريخ السياسي والاجتماعي العربي للوصول إلى الأسباب التي أدت لنشوء الواقع الذي يعيش العرب تحت وطأته، وربّما يكون المفكّر السوري برهان غليون من الباحثين العرب الذين قدموا مساهمات علمية تاريخية تُجيب عن أسئلة معلّقة كثيرة تشغل البال العربي، ففي كتابه "سؤال المصير: قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية "، يبدأ غليون جولة نقدية للتجربة الإصلاحية العربية منذ مُشارفة الحكم العثماني على النهاية، مرورًا بحروب الاستقلال القُطري العربية أو التسويات السياسية لأجله، وصولًا إلى ما استقر عليه حال العرب اليوم، فاحصًا نظرة الإصلاحيين العرب والمسلمين للحداثة التي برزت أهميتها بعد أن سادت القناعة في أوساط النخب الإصلاحية والفكرية العربية بالتفوق الحضاري الغربي، مسلطًا الضوء على الظروف السياسية التي أثّرت في النقاش الإصلاحي، والسياقات الدولية وارتداداتها في المنطقة العربية، ودور ذلك في ترتيب أولويات النخب التي آمنت بضرورة التحديث، وباغتتها السيطرة والتجزئة الاستعمارية للبلاد العربية.
يجادل المؤلّف أن العرب لم يقفوا ضد الحداثة، بل يرى أن نخبهم أدركت مبكرًا، أن اللحاق بالأمم الحديثة يتطلّب السير على ما سارت عليه، والالتزام بالحداثة التي أصبحت خيارًا إجباريًا للحفاظ على البقاء.
يُخضع المؤلف الدول المُستعمِرة والنخب العربية التي ارتبطت بها لمُحاكمة تاريخية، مُحمّلًا إياهما مسؤولية إجهاض محاولات التحديث الآخذة بالتبلور، والتي نشأت في سياقٍ ليبرالي محلّي، فحين جاء المُستعمرون إلى المنطقة العربية التي جعلوها مُنافية للمنطق الجغرافي والتاريخي الذي اتسمت به منذ القدم، بسبب مشاريع التجزئة والتقسيم الاستعمارية، صارت مُقاومة تلك المشاريع أولوية قصوى في منظور النخب الفكرية والتيارات السياسية على مختلف ألوانها، الأمر الذي جعل نقاشات الإصلاح والتحديث واللبرلة هامشية في حينه، وهو ما أدى لسد الأفق التحديثي في البلاد العربية، واختطاف القرار العربي واستقلاليته التي لم تدم طويلًا، وفتح الباب في وقت لاحق للقوى العسكرية العربية للأخذ بزمام المبادرة السياسية في ظل عجز المكونات السياسية المختلفة عن فتح ثغرة في الجدار الذي حال دون إنجاز أي تقدم أو تحديث، فشهدت أقطار عربية عديدة، مثل مصر وليبيا وسورية وغيرها انقلابات عسكرية، أدت إلى تشكّل أنظمة سياسية في تلك الأقطار، تتعلم تجارب الحكم على أرض الواقع، ومن وحي التجربة. يرى المؤلف أن وجود أمم ومجتمعات متخلفة لا يعود سببه لخصوصية تلك المجتمعات، وإنما لعجز الحداثة نفسها عن تحديث البنى السياسية والاجتماعية لتلك الأمم، وأيضًا لوجود إرادة سياسية لدى القوى الدولية المهيمنة بالإبقاء على تخلف أمم، وتسهيل الحداثة لأمم أخرى، بما يتوافق ومصالحها الجيواستراتيجية.
تكمن القيمة الجوهرية في هذا الكتاب - كما أرى - أنه يقدّم مراجعة مهمة للتفاعل الفكري والسياسي العربي على مدى قرنين من الزمن، وتأويلًا لما انتهى إليه حال العرب اليوم، ويسلّط الضوء على محاولات عربية خيضت من أجل النهوض في الماضي، بما حوته من سلبيات وإيجابيات، ويضم في خاتمته أربع شروط حددها المؤلف لجعل التقدم الحضاري أمرًا ممكنًا، ويمكن تلخيصها بإدراك أهمية الحداثة وضرورتها، وإعادة بناء النظم السياسية على أسس ديمقراطية، وحل عقدة الغرب، وأن يتحمل العرب مسؤوليتهم العالمية وأن يتجرأوا على المبادرة. هذا الكتاب بتقديري، يمنحك قراءة جديدة للمئتي عام الأخيرة من تاريخ العرب، ولعل أحوج ما نحن إليه، أن نعي الماضي وتجاربه بعيدًا عما ألفناه وصار حقيقيًا في أذهاننا!