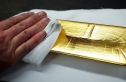الامتحان
الدكتور سلطان المعاني
تتسلّل مفردة «الامتحان» إلى وعينا منذ الطفولة كأنّها قدر لا فكاك منه. كلمة صغيرة، لكنها محيِّرة؛ نعمل من أجلها، نسهر من أجلها، نخافها أحيانًا، ونترقّبها كما لو أنّها لحظة وضع الرأس على المحك. امتحان في المدرسة، امتحان في الجامعة، امتحان في الوظيفة، امتحان في الحياة ذاتها. كأنّ الوجود سلسلة من «أسئلة» تُلقى في وجوهنا، وإن أحسنّا الإجابة كوفئنا، وإن عجزنا أُعيد علينا السؤال بأشكال أخرى.
يأتي الأستاذ، أو المدير، أو «النظام» كلّه في هيئة مُمتحِن كبير، يحمل ورقة الأسئلة أو نموذج التقييم، يسأل، يراقب، يقيّم، يوزّع شهادات النجاح ورسائل الفشل. يتقدّم الطالب إلى الورقة كما يتقدّم المتّهم إلى منصة الشهادة؛ يجيب تحت ضغط الوقت، وتحت عينٍ تراقب، ومعرفةٍ مسبقة أنّ هناك علامة ستُمنح ومصيرًا سيتحدّد. هنا تتخفّى أحيانًا «عبودية المنطق»: منطق واحد للسؤال، جواب واحد صحيح، طريقة واحدة للتفكير هي المقبولة، وأي خروج عن هذا المسار يساوي صفرًا على الورقة، حتى لو حمل هذا الخروج إبداعًا أو تفكيرًا مختلفًا.
ينبغي أن نسأل بهدوء: متى بدأت فكرة الامتحان؟ متى ظهر هذا الكائن الغريب الذي يقيس المعرفة بوقت محدّد، وبورقة محدودة، وبمعيار جاهز؟ في التراث الإنساني القديم ارتبط الامتحان بالابتلاء والاختبار الوجودي؛ امتحان الإيمان، امتحان الصبر، امتحان الأخلاق. كان الامتحان جزءًا من مسار حياة لا تُقسّم إلى فصول دراسية، وإنما إلى مواقف كبرى تَظهر فيها المعادن الحقيقية للإنسان. ومع الزمن تحوّلت الفكرة إلى آلية مؤسسية: مدارس، جامعات، مسابقات، اختبارات قبول، امتحانات مهنية. خرج الامتحان من حقل المعنى الوجودي إلى حقل الإجراء الإداري.
يتحوّل السؤال هنا من «متى بدأ الامتحان؟» إلى «لماذا يستمر بهذا الشكل؟». ما الذي يدفع المجتمعات إلى الإصرار على نموذج الامتحان الذي يحوّل الإنسان إلى رقم، وإلى علامةٍ على ورقة، وإلى حكمٍ نهائي على كفاءةٍ أو فشل؟ يُقال إن الامتحان ضرورة لضبط الجودة، وللتفريق بين المجتهد والمتقاعس، ولمنح الشهادات على أساس عادل. في الظاهر يبدو ذلك مقنعًا، غير أنّ جزءًا كبيرًا من الامتحانات يتحوّل في الممارسة إلى نوع من «العبودية الصامتة»؛ عبودية للمنهاج المغلق، للسؤال النمطي، للوقت القصير، لتوقعات الممتحِن أكثر من توقّعات الحياة.
تُغيّر فكرة الامتحان شكل العلاقة بين المعلّم والمتعلّم. حين تُصاغ العملية التعليمية كلها حول لحظة الامتحان، ينقلب المعلّم من رفيق طريق إلى مراقب، وينقلب المتعلّم من باحث عن المعنى إلى صائد للعلامة. تتحوّل الحصة إلى تدريب على «كيف تنجح في الامتحان»، لا على «كيف تفهم العالم». يَحفظ الطالب الجواب كما يُحفظ نصّ مقدّس لا يُمس، ويخشى أن يغامر بفكرة جديدة كي لا يخرج عن الإجابة النموذجية. هنا يفقد الامتحان روحه الأولى بوصفه مغامرة في الذهن، ويصبح عقوبة محتملة أو تهديدًا مستمرًّا.
بعض الامتحانات ضرب من العبودية فعلًا؛ عبودية للخوف، للخجل من الرسوب أمام الأسرة والمجتمع، لهيمنة الأرقام على صورنا عن أنفسنا. طالبٌ واحد يحصل على علامة متدنّية في اختبارٍ ما؛ فيُسحب الحكم بسرعة: أنت ضعيف، أنت فاشل، أنت «لا تصلح». تنسى المدرسة أنّ الامتحان التقاطٌ خاطف للحظة في حياة متعلّم، وأنّ الإنسان أوسع كثيرًا من ورقة وقلم وساعتين من الزمن. يَسهل أن يتحوّل الامتحان بذلك إلى أداة إذلال ناعمة، تؤطّر الشخص في صورة لا تطابق ما يمكن أن يصير إليه لو أُتيح له فضاء أرحب للتعلّم والتجربة.
ومع ذلك، لا يمكن إلغاء فكرة الامتحان تمامًا؛ الإنسان يحتاج إلى نوع من «الاختبار» كي يعيد النظر في نفسه، ويقيس مسافة ما تعلّم، ويتأكّد من قدرته على الفعل في العالم. غير أنّ الفرق جوهري بين امتحانٍ ينطلق من منطق السيطرة والفرز، وامتحانٍ آخر ينطلق من منطق النموّ والتقدّم. الأول يصنع طابورًا من الناجين والراسبين، والثاني يفتح بابًا للأسئلة الجديدة، يضع المرء أمام مرآته لا أمام مقصلة.
ما الذي يمنح الامتحان شرعيته إذن؟ الشرعية لا تأتي من كونه تقليدًا مدرسيًّا قديمًا، ولا من السلطة التي تحميه، وإنما من عدالته، ومرونته، وقدرته على كشف الإمكانات بدل حبسها. الامتحان الشرعي هو الذي يحترم اختلاف أنماط الذكاء، ويتيح أكثر من طريق للإجابة، ويقيس التفكير، لا القدرة على الحفظ وحدها. هو الذي يترك هامشًا للدهشة، ومساحة للخطأ الذي يُعدّ جزءًا من مسار التعلم، لا وصمة دائمة.
يمكن أن يُعاد تخيّل الامتحان بوصفه «حوارًا» لا محاكمة. يسأل المعلّم ليكشف طريقة تفكير تلميذه، لا ليصيد عثرته. يقدّم سؤالًا مفتوحًا يحتمل تعدّد الإجابات، ويصغي إلى الحجّة، ويحتفي بالمسار الذي قاد الطالب إلى استنتاجه. عندها يتحوّل الامتحان إلى مساحة حوارية يتحمّل فيها المتعلّم مسؤوليته عن فكره، ويتحمّل فيها المعلّم مسؤوليته عن الأسئلة التي يطرحها وعن المناخ الذي يخلقه حولها.
وعلى مستوى أوسع، يختبر المجتمع نفسه بأسئلة كبرى: كيف نربّي أبناءنا؟ كيف نقيس كفاءتهم؟ كيف نُعرّف النجاح؟ الامتحان هنا يتجاوز القاعة المغلقة إلى مساحة الحياة كلّها. أن يتحرّر الإنسان من «عبودية الامتحان» لا يعني أن يرفض السؤال، ولكن أن يستعيد حقّه في صياغة السؤال أيضًا، وأن يحوّل الامتحان من لحظة خوف إلى لحظة وعي؛ من ورقة موقّتة إلى تراكم من الخبرة والمعرفة والاختيار الحرّ.
ربما آن الأوان أن نعيد تعريف الامتحان في حياتنا: لا بوصفه سوطًا معلّقًا فوق رؤوسنا، ولا بوصفه بوابة ضيقة يقف عليها حارس قاس، وإنما بوصفه وقفة تأملية نراجع فيها أنفسنا، ونعترف بنقاط ضعفنا وقوتنا، ونخرج منها أكثر إنسانية، لا أكثر خوفًا. عندها فقط لا يعود الامتحان عبودية، وإنما يصبح خطوة واعية في طريق طويل اسمه التعلّم.