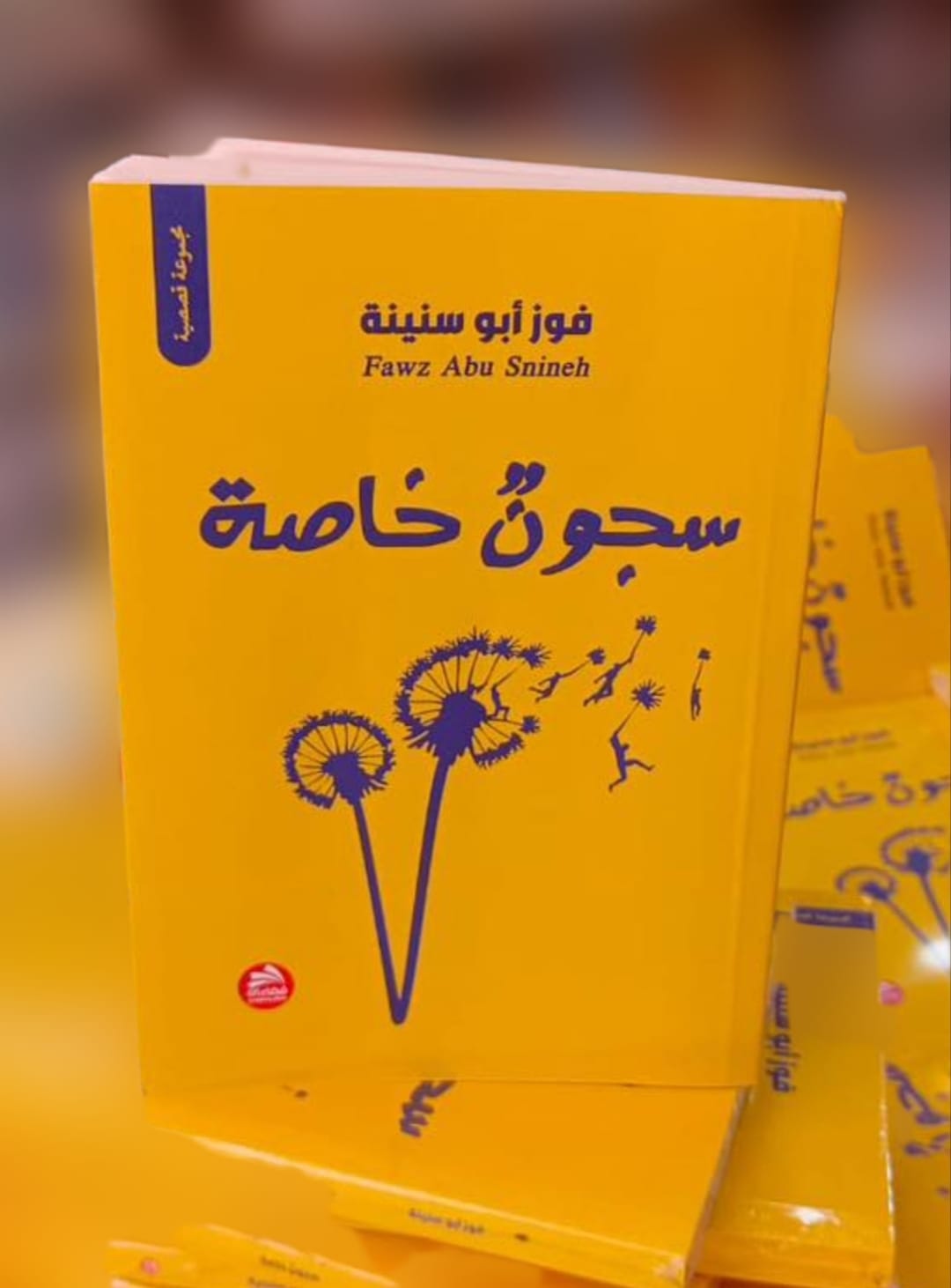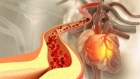نبض البلد -
قراءة: أُسَيْد الحوتري
أدب السجون هو أحد أفرع الأدب التي تحظى بأهمية خاصة على المستويين العربي والعالمي، إذ يعكس تجربة الإنسان في أقسى مظاهر القيد والاغتراب، كما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنهج التحليل النفسي الذي يكشف أبعاد الصراع النفسي والذاتي في ظل العزلة والقمع والقهر. هذا الأدب لم يقتصر على سرد التجارب الواقعية للاعتقال فحسب، بل توسع ليشمل أبعادًا نفسية، اجتماعية، وفلسفية عميقة تعكس تعدد أشكال السجن وتأثيرها على النفس البشرية. من أبرز المجموعات القصصية العربية التي أثرت هذا الحقل الأدبي، نجد مجموعات مثل «سجين المرايا» للمصري صنع الله إبراهيم، و«الزنزانة رقم 7» للفلسطيني محمود شقير، و«السجن برتقالي اللون» للعراقي أحمد خلف، وهي مجموعات تناولت التجربة الاعتقالية بتنوع موضوعي وفني عالٍ. وعلى الصعيد العالمي، برزت مجموعات مثل «بيت السجين» للروسي (فيودور دوستويفسكي)، و«كلاب النار» للأرجنتيني (خوليو كورتاثر)، و«سجن متمرد» للكيني (كينيث كيبيمبو نغوغي)، حيث مزجت بين التجربة الواقعية والرمزية في تصوير القيد النفسي والمادي.
في هذا السياق، تأتي مجموعة «سجون خاصة» للقاصة فوز أبو سنينة لتقدم رؤية جديدة ومتميزة في أدب السجون، لتسرد تجربة الاعتقال المادي، ثم تتجاوزه لتتوسع في مفهوم السجن ليشمل أبعادًا أعمق من القيد الجسدي. تفتح هذه المجموعة أبوابًا متعددة لفهم أنواع السجون التي تحاصر الإنسان، وتجعل القارئ يعيش مع كل قصة أبعادًا مختلفة من المعاناة الإنسانية.
في قصة "رحلة شفاء" من مجموعة سجون خاصة لفوز أبو سنينة، يتجلّى مفهوم السجن في أبعاده الأشد قسوة: لا ذلك المحاط بالأسوار الحديدية والجدران الأسمنتية، بل ذاك الكامن في النفس، في الذاكرة، في الجسد الذي أصبح عبئًا لا مأوى. فالبطلة، ضحية اعتداء وحشي، لا تجد خلاصًا من سجن العار والذنب والخزي، سجن لا يرى الآخرون جدرانه، لكنه يفتك بها في كل لحظة. تقول: " وبقيت أنا أصارع الكره الجارف الذي اعتراني...كرهي لنفسي... لضعفي... لجسدي... للناس... لهذه المدينة التي سمحت باغتيال أنوثتي" (12). هذه العبارة الكثيفة تختصر حالة الاغتراب التام عن الذات والمكان؛ فالكراهية، هنا، ليست شعورًا عابرًا، بل جدرانًا تُبنى بين الضحية وكل ما كان يشكل عالمها. إن السجن النفسي الذي تعيشه المرأة هو التجسيد الحيّ لما يسميه علم النفس "الصدمة المعقدة" حيث لا تقتصر آثار الاعتداء على الحدث نفسه، بل تتسع لتشمل الإدراك الذاتي والهوية الجسدية والعلاقة بالآخرين. وهي تصف هذا الأسر القاسي بمرارة حين تقول: "لم يسأل أحد كيف أمضيت هذه السنوات وأنا محبوسة داخل هذا الجسد الذي تفوح منه رائحة العار والدنس" (14). هنا يصبح الجسد، في الحكاية النفسية، مصدرًا للنفور الذاتي، وللسجن الداخلي، كأن الذات أصبحت حبيسة في جسد لم تعد تملكه ولا تعرفه. وهذا ما يسميه بعض المنظرين النفسيين بـ"الانفصال الجسدي"، حين يتوقف الجسد عن كونه مرآة الذات ويغدو عبئًا يتبرأ منه الوعي. في المقابل، هناك المفارقة الموجعة في حال المعتدي، الذي يقبع في سجن مادي لكنه يبدو مرتاحًا، بل مستمتعًا، كأن جريمته لم تكن سوى نزوة عابرة لا تستحق الندم. تقول الساردة: "يوم أخذوه من أمامي ضاحكا متحديا...السجن لأمثاله نعمة..فندق يأكل فيه..يشرب..يتآمر..يتسامر وينام وكأنه لم يقتلني يوما" (13). هذه الصورة تقلب مفاهيم العدالة رأسًا على عقب: فالمجرم يتمتع بـ"رفاهية" زنزانته، بينما يعذبُ الضحيةَ السجن الذي تحمل في داخلها، دون أن تشفع لها حريتها.
حين تقرر الضحية أخيرًا قتل مغتصبها، فإن فعلها لا يأتي كتعبير عن انتقام بقدر ما هو محاولة يائسة للتحرر من قيود هذا السجن الداخلي. لكنها، بمفارقة مأساوية، لا تخرج من سجنها، بل تنتقل إلى زنزانة مادية جديدة. سجن آخر، ملموس هذه المرة، لكنه لا يُلغي ذاك الآخر المزروع في أعماقها. وهكذا تصبح البطلة رهينة المحبسين: محبس الصدمة النفسية التي لم تُشفَ، ومحبس العقوبة القانونية التي لم تعترف بألمها كجزء من سياق جريمتها.
في هذا العمل، لا يتجلى السجن فقط كمكان، بل كحالة وجودية، كعقوبة مزدوجة لكونها ضحية أنثى في مجتمع لا يرى الألم إلا إذا كانت له أبعاد ملموسة. ويبقى السؤال النفسي الأعمق: هل كان القتل محاولةً لهدم السجن القابع داخلها؟ وإن كان كذلك، فهل يمكن هدم سجنٍ لم تصنعه الخرسانة بل الذكريات؟ ترسم فوز أبو سنينة في "رحلة شفاء" خريطة مؤلمة للصدمة والنجاة المستحيلة، وتبرز كيف تكون العدالة، أحيانًا، طيفًا بعيدًا لا يُدرك، في عالم تُسجن فيه الضحية مرتين، ويخرج الجلاد من السجن مرفوع الرأس، أو مدفونًا… بحرّية.
في قصة "عشرة كاملة"، تُسدل فوز أبو سنينة الستار عن نموذج آخر من السجون، لكنه أثقل من الجدران الخرسانية، وأقسى من القضبان الحديدية. إنه "سجن الزوج" الذي تتوارى خلفه آلام النساء في صمت، تحت وهم الحياة المستقرة وواجهة "القفص الذهبي". فالأنثى هنا لا تعيش حريتها، بل تعاني من علاقة تحوّلت فيها مؤسسة الزواج إلى نظام قمعي صارم، ومحبس نفسيّ خانق، يحاصرها فيه زوج متسلّط يمارس سلطته بألوان من العذاب. إنه رجل يقبض على روحها بقبضة من حديد، يتجاهل وجودها، يوبخها دون سبب، يعنفها لفظيًا أو جسديًا، ويهدم ثقتها بذاتها، لَبِنَة بعد لبنة، حتى تتحوّل من امرأة حية نابضة، إلى شبح يقبع في ظلّ ذاته. تقول صاحبة القصة في لحظة بوح: "ثم أهداني بعد مهمتي الفاشلة تلك، هذا (التوباز) [حجر كريم] ترابي اللون ليذكرني أنه لا مكان لي خارج هذا الجدار سوى تحت التراب" (35). هذا التصريح ليس تذمر من هدية سيئة، بل صرخة دفينة تكشف عن أعماق الانهيار النفسي. الحجر الكريم، الذي يفترض أن يرمز للحب أو القيمة أو الامتنان، يتحول إلى رمز يُذّكر بالقبر! فـ"التوباز الترابي اللون" يشير إلى التراب: الموت، النهايات، الدفن. والزوج، بإهدائه هذا الحجر، لا يُعبر عن مودّة، بل عن تهديد مقنّع، كأنه يقول: إما هذا القفص، أو القبر. إننا بإزاء حالة من الحبس التعسفي، والقتل النفسي، الذي يُمارس باسم المؤسسة الزوجية. هذا النوع من السجن يفتك ببطء، عبر التجاهل المستمر، التحقير، التقييد، ومصادرة الإرادة. وهو بذلك لا يُجرد المرأة من حريتها الجسدية فقط، بل من هويتها، صوتها، وحقها في الوجود المستقل.
من المنظور النفسي، فإن هذه المرأة تقع ضحية ما يسمى بـ"متلازمة السجين" أو "الانحباس المكتسب"، حيث تبدأ مع الوقت بتطبيع وضعها داخل السجن الذهبي، بل والشعور بالذنب حيال رغبتها في التحرر، وقد تلوم نفسها على ما يفعله الزوج بها. أما القفص الذهبي نفسه، فهو في التحليل النفسي أشبه بـ"البيت القاتل"، حيث يُقدَّم للمرأة إطار اجتماعي مقبول، لكنه يخفي في باطنه آلية قهر مستدامة. وهكذا، يتحوّل البيت، الذي يُفترض أن يكون موئلَ الحماية والسكينة، إلى سجن فولاذي، لا أبواب فيه للخروج، ولا نوافذ للضوء، ولا مفرّ منه إلا إلى التراب، حيث تقول الساردة بمرارة: "لا مكان لي خارج هذا الجدار سوى تحت التراب" (35). بهذه الصورة القاتمة، تُفكك القاصة صورة الزوج النرجسي، لتكشف أن أشدّ أنواع الأسر، ليس ذاك الذي تغلّق فيه الأبواب، بل ذاك الذي تُطلى قضبانه بالذهب!
أما في قصة "أسفل عمود الكهرباء"، فيتجلى السجن لا كزنزانة يتعفّن فيها بالجسد، بل كجدران صامتة تحاصر النفس، باسم العزلة والوحدة، حتى يصير الإنسان نزيلًا في قوقعة لا مرئية، لا يُدركها أحد سوى من ذاق مرارتها. الساردة، وهي أكثر من عرف "المجنون"، تضعنا أمام مأساة رجل لم يحبسه أحد، بل انسحب من العالم بنفسه، كما تقول: "لا أحد يعرفه مثلي... اعتزله الناس، بل كان هو من اعتزل عالمهم الذي لا مكان له فيه... لا أحد يشعر به... ولا أحد يراه" (147). هذا السجن اختياريّ في ظاهره، قسريّ في جوهره، فالمجتمع لم يكن يومًا رحيمًا بمن يختلف عنه، وأبسط تفسير جاهز دوما: "يقولون عنه بأنه مجنون.. محبط.. مكتئب" (147)، وكأن التهم الثلاثة كافية لإغلاق كل أبواب الإنصات والفهم والتعاطف. الوحدة هنا ليست عزلة هادئة، بل زنزانة خانقة، تنهش الذات حتى الهذيان. تقول الساردة: "أسمعه في حدة وحدته يهذي ..." (148)، وكأن كثافة الصمت حوله دفعت عقله للصراخ. لكنه، رغم ما يبدو من يأس، يصرّح: "لم تعد نفسي تخاف العتمة، لم تعد تخاف من الوحدة..." (149). هنا يبرز التحول النفسي العميق، فالرجل لم يعد يقاوم سجنه، بل صار يساكنه، يصادقه، يعيش معه كأنه حر. وهذا في علم النفس ما يُعرف بآلية "التكيف الدفاعي"، حيث يتحوّل الألم المزمن إلى مأوى، ويتحول الجرح إلى جزء من الهوية.مع ذلك، فالمفارقة الكبرى أن هذا السجن ذاته الذي عزل "المجنون" عن الناس، منحه بالمقابل، حريّةً داخلية لا يحوزها "العقلاء". يقول: "لم أعد أرتعد من الناس أو المجهول، لم تعد تتسلل الكآبة إلى أوصالي فتحرمني من الفرح، لأنه قد صار لي بين دفات الحلم مغامرات..." (150). لقد اكتشف في الحلم ما عجز عنه الواقع: معنى للفرح، مكانًا له، ولو كان هذا المكان في عالم الخيال. إلا أنّ كل سجن، مهما تأقلم معه السجين، يبقى قاتلًا إن طالت مدته. وفي النهاية، لم تكن مغامرات الحلم كافية لردم هوة الواقع. في لحظة ختام تراجيدية، يقرر "المجنون" أن يهرب... لكن لا إلى أحضان البشر، بل إلى النور، إلى الخلاص المطلق، فيهرب كما خطط، "وعندما حل الصباح... استيقظ سكان حي صغير في مكان ما من هذا العالم فزعًا على جثة جارهم "المجنون"" (153). لقد قفز من الشرفة نحو الشمس، ربما ظنّها بابًا للهروب الأخير. وكان ما كان، ومن الوحدة ما قتل. هذا المجنون لم يكن مجنونًا بقدر ما كان شفافًا حدَّ التهشّم، هشًّا حدَّ التبخر في الضوء. لقد ضاق بعالمٍ لا يسمع، لا يرى، لا يعترف، فاختار نورًا لا يُطفأ، ولو كان فيه فناؤه. فالوحدة، حين تستحكم، تصبح قيدًا أثقل من الحديد، وسجنًا من لا يرى قضبانه، لا ينجو منه إلا بالموت.
وهكذا، قدّمت فوز أبو سنينية في «سجون خاصة» تجربة أدبية متكاملة تُجسد تعددية أوجه السجن، من القيد المادي عبر الزنازين ، إلى القيد النفسي والذاتي، مرورًا بسجون تشيدها الجريمة والزوج والمجتمع. ومن خلال أسلوبها الشعري المكثف وتحليلها الدقيق لحالة الإنسان في أسره، تضع المجموعة علامة فارقة في أدب السجون، وتفتح نافذة نقدية نفسية وفلسفية تفسح المجال لفهم أعمق وأوسع للمعاناة الإنسانية خلف القضبان وخارجها.
يذكر أن الكاتبة فوز أبو سنينة، فلسطينية-أردنية ولدت في القدس الشريف، وتعيش حالياً في إيطاليا، تحمل في قلبها هموم وطنها ووجع شعبها. أصدرت مجموعتين قصصيتين؛ الأولى بعنوان "كسرة من روح" عام (2023)، والثانية "سجون خاصة" عام (2024) عن دار فضاءات.