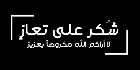كيف تنبأ ابن خلدون بسقوط دول ونشوء أخرى؟ لماذا تقوم الدول ولماذا تسقط؟ يقولون إن السياق التاريخي يصوغ الأفكار والحضارات، أو كما يقال: التاريخ هو فعل البشر في الأرض، والجغرافيا هي فعل الخالق في الأرض. وهنا السياق التاريخي الذي عاش فيه ابن خلدون من سقوط دولة الموحدين، وقيام دول أخرى، وسيطرة المماليك على الشرق، وآثار الغزو المغولي التي ما زالت قائمة، وتهديد قديم جديد.
كل ذلك ساهم في صياغة هذا العقل وسعيه الحثيث للوصول إلى الأسباب خلف ما يراه، فهذه الظواهر حتمًا مرتبطة بمسبّبات أدّت إلى حدوثها.
هناك فئة من البشر تسعى لتطبيق المعرفة على الواقع، حتى تعطي صورًا واضحة لما من الممكن أن يحدث، وتصل إلى تنبّؤ بدقة وبنِسب عالية جدًا، وهذا ما قام به ابن خلدون، حيث تنبّأ بسقوط الأندلس مثلًا قبل قرون.
والسبب هي النظرية التي وضعها في العمران والدولة، درس الظواهر التاريخية بعقلانية لا بعاطفة، ووفق قوانين عامة، لا كحوادث معزولة، واستخدم أدوات التحليل، التفسير، المقارنة، والربط بين الأسباب والنتائج.
وفكر في: لماذا حدث هذا؟ ما العوامل؟ هل تكرر؟ هل هناك نمط يمكن تعميمه؟ ومن هنا تجد أن ابن خلدون طبّق في مقدمته قواعد شبيهة بالبحث العلمي، مثل: التحقيق في الأخبار، فقال: كثيرًا ما يغفل الناقلون، ويخلطون بين الممكن والمحال، وهنا أخضع النصوص للتمحيص والمنطق، واعتمد على العقل لا على النقل وحده.
ويرى أن الحوادث يجب أن تُفسّر بأسبابها الواقعية (اقتصادية، اجتماعية، سياسية)، لا مجرد الغيبيات. مثال: لم يقل إن الدول تسقط فقط لعقوبة إلهية، بل بسبب الترف، وغياب العصبية، والصراعات.
ورصد القوانين العامة للتاريخ، فقال: للتاريخ في ظاهره إخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. كان يبحث عن قوانين تحكم نشوء الدول وسقوطها، مثلما تتحكم العلوم بالطبيعة. وقارن بين الحالات التي كانت تعاصره، قارن بين الأندلس والمغرب والمشرق، واستنتج منها قواعد متكررة، مثل: كل دولة تبدأ بجهاد وتنتهي بترف، أو إذا ضاعت العصبية، ضاعت الدولة.
يرى أن الدول كائن حي، ولادة فقوة فاستقرار ثم انحدار وموت، نشأة وتمكين واستقرار ثم رفاه وترف وبعد ذلك انحدار وسقوط. وهي تقوم على أساسين في البعد التشكيلي للدول، هما العصبية والقيادة الصارمة. وعندما يصعد الطامعون إلى مراكز قيادية، ويصيب الترف وضعف الرابط الأخلاقي أو الديني أفرادها، يبدأ سقوط الدول، قد يطول وقد يقصر بناءً على حدّة وضعف الأسباب التي تسهم في ضعفها.
العصبية الرابط العجيب الذي يساهم في خلق بيئة ترابطية تكافلية واجتماعية بين أعضاء مجموعة ما، بحيث تصبح هذه المجموعة قادرة على تشكيل قوة ذات بُعد أو هدف وجودي أو أخلاقي أو ديني، وتشكل هذه القوة لحمة اجتماعية واقتصادية وعسكرية قادرة على تحديد وجود جغرافي، بما يتطلبه ذلك من تحديات. هناك مجموعة من الأحداث والوقائع دفعت مجموعة من البشر إلى تشكيل اتحاد بصورة ما.
هنا سعى ابن خلدون إلى محاولة تفكيك هذه الوقائع والأحداث، واستقراء الحالات المشابهة، سواء في واقعه أو التاريخ، ثم الوصول إلى نموذج معين لتطبيقه على الحالات المستقبلية، واستقراء ما يمكن أن يقع فيها. ولذلك، بحسب قوة هذا الرابط، وبحسب العزم والإرادة الموجودة عند أفراده، استطاع أن يعرف هل ستستمر قوة هذه المجموعة لتحقيق الهدف، أم أنها ستضعف وتنكسر.
عصبية ابن خلدون هنا من الممكن أن تأخذ بُعدًا أكبر، برأيي، من ذلك البعد الذي يشكل دولة ما أو مجتمعًا ما، وهذا ما حدث مع الكيان أخيرًا، فدعم الدول الغربية العسكري والمادي والإنساني، هو نوع من العصبية التي تساهم في استمرار هذا الكيان وبقائه. وهذا الدعم ساهم في بقاء العصبية الموجودة بين أفراد هذا الكيان وعدم تفككها، ولو ضعفت العصبية الخارجية، لكانت سببًا رئيسيًا في تفكك العصبية الداخلية، وسرعة القضاء على هذا المجتمع الطفيلي.
وفي المقابل، ضعف العصبية في المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة كلها، هو سبب رئيسي في عدم قدرة المقاومة على تحقيق أهدافها. ولو كانت هذه العصبية متحققة، لكانت النتائج مختلفة، مع الإقرار بأنها موجودة على مستوى غزة فقط، ولكنها لم تتحقق على مستوى الأرض الفلسطينية بشكل كامل.
وهنا سعى ابن خلدون لمحاولة تفكيك هذه الحالة، والوصول إلى أسباب تشكّلها وقوّتها وضعفها، واستطاع أن يصل إلى مجموعة من القوانين تحكم نشوء الدول وسقوطها.
وهنا نجد أن هذه القوانين استطاع الغرب أن يوظفها، بأبعاد أخرى استعمارية إحلالية أو هيمنة وسيطرة، وسعى من خلالها إلى خلق نزاعات وصراعات بين أطياف المجتمع الواحد، وبحث عن أسباب ضعف وقوة المجتمعات.
حتى إنه اعتمد تصنيفًا أكثر دقة، فما يتعلق بالمجتمعات التقليدية أو غير الغربية – بين هلالين: غير المتحضّرة – والتي يسعى للسيطرة عليها واستغلالها، وضع لها علمًا سماه الأنثربولجي، وهو كيف تُمارس السلطة هناك، وتُنظَّم المجتمعات، وتُدار الصراعات ثقافيًا في هذه المجتمعات المتخلفة.
في المقابل، أطلق على ما يسميه إدارة المجتمعات الحديثة اسم العلوم السياسية، وهنا سعى لأن تكون هذه الممارسة السياسية كمية وقانونية ومؤسسية، حتى لا يقع فيما وقعت فيه الشعوب غير المتحضرة.
ومن هنا، وبقراءة بسيطة، تستطيع أن تُصنّف أي صراع يحدث في المجتمع أو في الأمة، بناءً على هذه القواعد: وهل يقع هذا الصراع في المصلحة العليا للدولة أو الأمة، أم يصب في إضعاف وتفتيت العصبية التي تقوم عليها الدولة أو الأمة؟
فقد أصبحت القاعدة واضحة.